
✍🏼 ملهي شراحيلي
من أمتع المُتع التي أستمتع بها في جلساتي الخاصة مع نفسي، ومع من حولي، التذوق اللغوي!.
وهي لعبتي المفضلة منذ أن عرفتُ القراءة والكتابة، ولا أظن أن يوماً مرّ بي، ولم أجد كلمةً أتذوقها، وأقضي دقائق وربما ساعات في تجريدها وإعادة ترتيبها، وبعثرة أوراقها، والبحث عن جذورها وفروعها، متقصياً أصلها، مستمتعاً بفصلها ووصلها.
كلماتٌ كثيرة في لغتنا العربية الجميلة، بعضها فصحى، وبعضها مُعرّبة، وأخرى هجينة. بعضها عامية، وبعضها عالمية.
لكن جميعها مبنية من حروف اللغة العربية!!.
ومن نافلة القول، ومما لايخفى على القارئ الكريم، أن الكلام الذي يجري على ألسنتنا، وأداة التواصل بيننا، مكون من خمسة أقسام لا سادس لها.!!.
بعبارة أخرى: أن أي كلمة ننطقها، إما أن تكون:
حرفاً
أو فعلاً
أو إسماً
أو صفةً
أوظرفاً.
ثم إن علماء اللغة قسّموا الحروف إلى أقسام، وكذلك فعلوا مع الأفعال، والأسماء والصفات، والظروف.
ووضعوا قواعد اللغة على هذا الأساس.
ولكن وبما أن الإختلاف من سمات البشر، فلا غرابة أن يختلف علماء اللغة في بعض التقسيمات، مما انعكس على
بعض القواعد اللغوية، ومن ذلك، على سبيل المثال:
عدم اعتراف مدرسة الكوفة اللغوية بالقسم الثالث من أقسام الفعل، وهو فعل الأمر، وزعموا أن الفعل إما أن يكون ماضياً أو مضارعاً فقط، بينما ترى مدارس لغوية أخرى، أن الفعل ينقسم إلى:
ماضٍ
مضارع
وأمر.
وهو الشائع عند أهل اللغة.
هذا الإختلاف وغيره من الإختلاف الصرفية والنحوية التي لا أريد أن أقحم نفسي في شرحها، ليس لأن شرحها يطول، والحديث فيها ذو شجون، والقارئ المُطّلع، يعلم أن الحديث في هذا الأمر أكبر من أن يحتويه مقال، وحديثي هنا ليس عن قواعد اللغة، ولا عن الفوارق الصرفية، والاختلافات النحوية، وإنما ذكرتُ ذلك كمقدمة بسيطه، لكي أذكّر القارئ الكريم أن اللغة العربية رغم أنها لاتحتوي إلا على ٢٨ حرفاً، إلا أن كل كلمة منها تحتوي على عشرات إن لم تكن مئات المعاني، ليس فقط بحسب تصنيفنا لتلك الكلمة، ولا بحسب مانصّت عليه قواعد اللغة، وإنما بسبب استخدام تلك الكلمة ونشأتها وتطورها عبر الزمن حتى وصلت إلينا، بصورتها الحالية.
إن كل كلمة في اللغة العربية، سواءً كانت مكوّنة من حرف أو حرفين أو حتى أكثر من خمسة حروف، إذا أعملنا فيها ذكاؤنا اللغوي، سوف نكتشف أنها تولدت من كلمة أخرى كانت قبلها، سواءً كانت الكلمة الأولى لاتزال مستعملة أو اندثرت، وأن كل كلمة نستخدمها الآن سوف تأتي بكلمات لاحقة سواءً في عصرنا هذا أو العصور اللاحقة.
وليس أوضح على ذلك من دليل، من المعاجم اللغوية والقواميس، التي تزخر بالمفردات التي كانت مستعملة في وقتٍ من الأوقات، ثم اندثر استخدامها لذات المعنى، واستُبدلت بكلمات أخرى!!.
ولك في الشعر الجاهلي أروع الأمثلة على ما مات من كلمات، وما تولد من مفردات من ذلك الشعر في العصور اللاحقة، حتى وصلنا إلى ماوصلنا إليه الآن من كلمات لم يُسمع مثلها في تلك العصور، ولم يتحدث بها الأولون، ولا غرابة أن يستبدلها اللاحقون.
صحيح أن بعضاً من كلمات الأقدمون لاتزال تجري على ألسنتنا إلى يومنا هذا، ولكن أكثر كلماتهم، رغم أنها عربية، وتستخدم ذات الحروف التي نستعملها الآن إلا أنها أندثرت، وتوقف استعمالها، وتغيرت حتى معانيها!!.
ورغم أنني لست متخصصاً في مجال اللغويات، ولا أعلم الكثير من علوم اللسانيات، إلا أنني أعتبر نفسي من المتخصصين في صناعة الكلمات، لسبب بسيط وهو أنني أتكلم.
فبما أنني أتكلم فأنا أعي ما أسمع من كلمات، وأفهم ما أقول من مفردات.
وكذلك هو حال باقي البشر ممن يستطيعون التواصل مع أمثالهم من البشر بواسطة الكلام، ولا أجد فرقاً بين كلمات فصحى، وكلمات عاميّة، لأنه ببساطة، بما أن كلماتي التي أقولها أو أكتبها مكونة من حروف عربية، فإنها عربية، سواءً استخدمها الأولون أم لم تكن في قاموسهم.
هذا يقودنا إلى أن الزمن يلعب دوراً كبيراً ليس في تغيير معاني الكلمات فحسب، بل وحتى إعادة ترتيب حروفها، ولذلك غالباً عندما مانسمع أو نقرأ بعض الكلمات، نفهم أنها جاءت من الماضي السحيق.
ومما لاشك فيه أن الكلام لايدل فقط على الزمان، فبعض الكلمات كأنها منارات من منارات الأرض، وليس أدل على ذلك من تعدد وتنوع اللهجات ليس في عموم الوطن العربي، بل وحتى في البلد الواحد.!!.
ومن وجهة نظري الشخصية أن الزمان والمكان، رغم أنهما من أهم العوامل في بناء وتشكيل الكلمات، إلا أن السر الأعظم يكمن في اللغة ذاتها!!.
إن كل حرف من حروف اللغة، وخاصة لغتنا العربية، له خصائص تميّزه عن غيره من باقي الحروف، على سبيل المثال، حرف الغين مثلاً!!
فأي كلمة تجد فيها حرف الغين، فإنها تدل على ظلام أو ظلمة ومشتقاتها، من معاني التغطية والإخفاء.
غيم، غروب، غراب، بغظ، بغي، لغط، غربة، غزير، غرغرة، غم، غل، غش، غشاء، غائر، غريزة، ..... الخ
وغيرها من الكلمات.
بينما الكلمات التي تضم حرف الصاد، تدل على الوضوح!!
صيف، صافي، صدق، قصد، صباح، قصر، صقر، صحراء، ...الخ
وهكذا باقي الحروف، وكلما كان الحرف أساسياً في بناء الكلمة كانت دلالته أقوى وسيطرته أوضح في معناها.
ولايخفى على القارئ الكريم، أن أغلب اختلافات معاني الكلمات، سببها أمرين:
الأول: تموضع حروفها، والعرب منذ القدم وإلى الآن تستخدم الإبدال، بحيث يضعون الحرف الثالث ثانياً واحياناً العكس، مثل قولهم زوج، وجوز.
وأحياناً يستبدلون حرفاً بحرفٍ قريب منه في النطق، فيبدلون حرف الميم، بالباء، والعكس.
أما السبب الثاني: فهي حروف العلة، وهي: الألف والياء والواو.
ولذلك تجد بعضهم ينطق كلمة العِشاء بالعشي، وكلمة ماء، مي، ومويه، وغار، غور....الخ.
وإذا ما تساءلتَ أخي القارئ الكريم:
ما الفائدة من التبحر في معاني الكلمات؟
ولماذا نضيع وقتنا وجهدنا في اكتساب مفردات جديدة، ونحن نكتسبها عفوياً عن طريق التحدث والتواصل مع من حولنا؟!
إن من أهم الأسباب التي تدفعنا للتبحر في معاني الكلمات، أننا نحتاجها ليس فقط للتواصل مع الآخرين، ولكن لنعبّر بها ومن خلالها عن مشاعرنا وأفكارنا، بل أن الكلمات التي نتحدث بها مع أنفسنا تأثيرها علينا أضعاف ما نسمعه من الآخرين، مما يعني أننا بحاجة أن نعمّق قاموسنا اللغوي، ونراقب ما يصدر منا من كلامات لأنفسنا.
يقول الفيلسوف والحكيم الصيني:
«راقب أفكارك... لأنها ستصبح كلمات.
راقب كلماتك...لأنها ستصبح أفعال.
راقب أفعالك... لأنها ستتحول إلى عادات.
راقب عاداتك....لأنها تكّون شخصيتك.
راقب شخصيتك..لأنها ستحدد مصيرك.»
لذا فلا غنى عن اكتساب مفردات وفهم المزيد من الكلمات في كل وقت من الأوقات.
ومن الوسائل التي تساعد على فهم الكلمات الغريبة تجذيرها، أي أن نبحث عن جذر الكلمة، لأن جذرها إن لم يوصلنا لمعناها المقصود، فإنه سوف يقرّبنا منها، ومع أن تجذير الكلمات علم من علوم اللغة ويحتاج إلى سعة إطلاع وذائقة لغوية إلا أن تفريغ الكلمة من حروف العلة يعتبر من الأدوات المساعدة للوصول إلى جذر الكلمة.
ومن الأدوات المساعدة في فهم الكلمات الغريبة، إعادة تركيب حروفها، أو بالأصح التلاعب في ترتيب حروفها، واستخراج كلمات منها، ونطقها أو كتابتها بالعكس.
لأنه في كل مرة تصادفنا كلمة نسمعها لأول مرة، فإن تحليلها وإعادة صياغتها، قبل حفظها لايثري قاموسنا اللغوي فحسب، بل يعمّق فهمنا لأنفسنا من خلال فهمنا للغتنا، التي بها نتواصل، مع أنفسنا ومع العالم الخارجي من حولنا.
نحن البشر تعرّفنا على أنفسنا وكل مايحيط بنا، من خلال التواصل اللفظي، أي بواسطة الكلام، مع أننا نمتلك العديد من أدوات التواصل مع أنفسنا والعالم من حولنا، إلا أن التواصل اللفظي، يظل أبسط الوسائل وأسهلها بين البشر، ليس لأنه عبارة عن كلمات، ولكن نوعية الكلمات ونبرة الصوت، لاتقل أهمية في عملية التواصل الكلامية.
وعلى قدر فهم الإنسان واستيعابه للكلمات، يستطيع أن يؤثر ويتأثر، في كل عملية تواصل، سواءً كان متكلماً أو مستمعاً.
وكلما تقاربت الأعمار وقربت الديار، وتساوت المواهب، وتشاكلت المذاهب، تحسنت لغة الحوار، وعلى النقيض من ذلك إذا اختلفت!!.
فالطبيب وإن كان حاذقاً، والخطيب وإن كان مفوهاً، لن يستفيد منهما من لم يفهم لغتهما، والحديث مع المعلم غير الحديث مع الراعي .
وكما قيل: كل إناءٍ بما فيه ينضح.
فالكلمات التي نسمعها كثيراً، سوف نرددها أكثر، بغض النظر عن نوعيتها، وحسنها ورداءتها.
إن أبسط مايمكن أن نصف به كلماتنا التي نتحدث بها، سواءً شفهياً أو كتابياً، أنها عبارة عن شجرة !!!.
ما يعني أنها كائن حي، قابل للنمو والتكاثر، وعلى قدر قاموسك اللغوي تكون شجرتك، فمنهم من تكون شجرته اللغوية أشبه ماتكون بنخلة، ومنهم من شجرته عُشَر، كما قال أبو العلاء المعري:
شَجَرٌ أَفضَلُهُ مُثمِرُهُ
وَمِنَ الناسِ نَخيلٌ وَعُشَر.
فهناك شجرة لها جذور ضاربة في أعماق الأرض، وجذع تقف عليه، وأغصان تتفرع منها فروع، تكسوها أوراق.
وشجرة كل واحد منا، كل ورقة فيها قابلة لأن تكون غصناً، وكل غصنٍ قابل لأن يكون فرعاً، وكل فرعٍ قابل لأن يكون جذعاً، تتمدد جذوره في أعماق وجدانك، أزهارها تحمل بنات أفكارك، وثمارها ما يتساقط من لسانك.
ألم تقرأ قوله تعالى:
﴿أَلَم تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِي السَّماءِ﴾
﴿تُؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذنِ رَبِّها وَيَضرِبُ اللَّهُ الأَمثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرونَ﴾
﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ اجتُثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ﴾.



























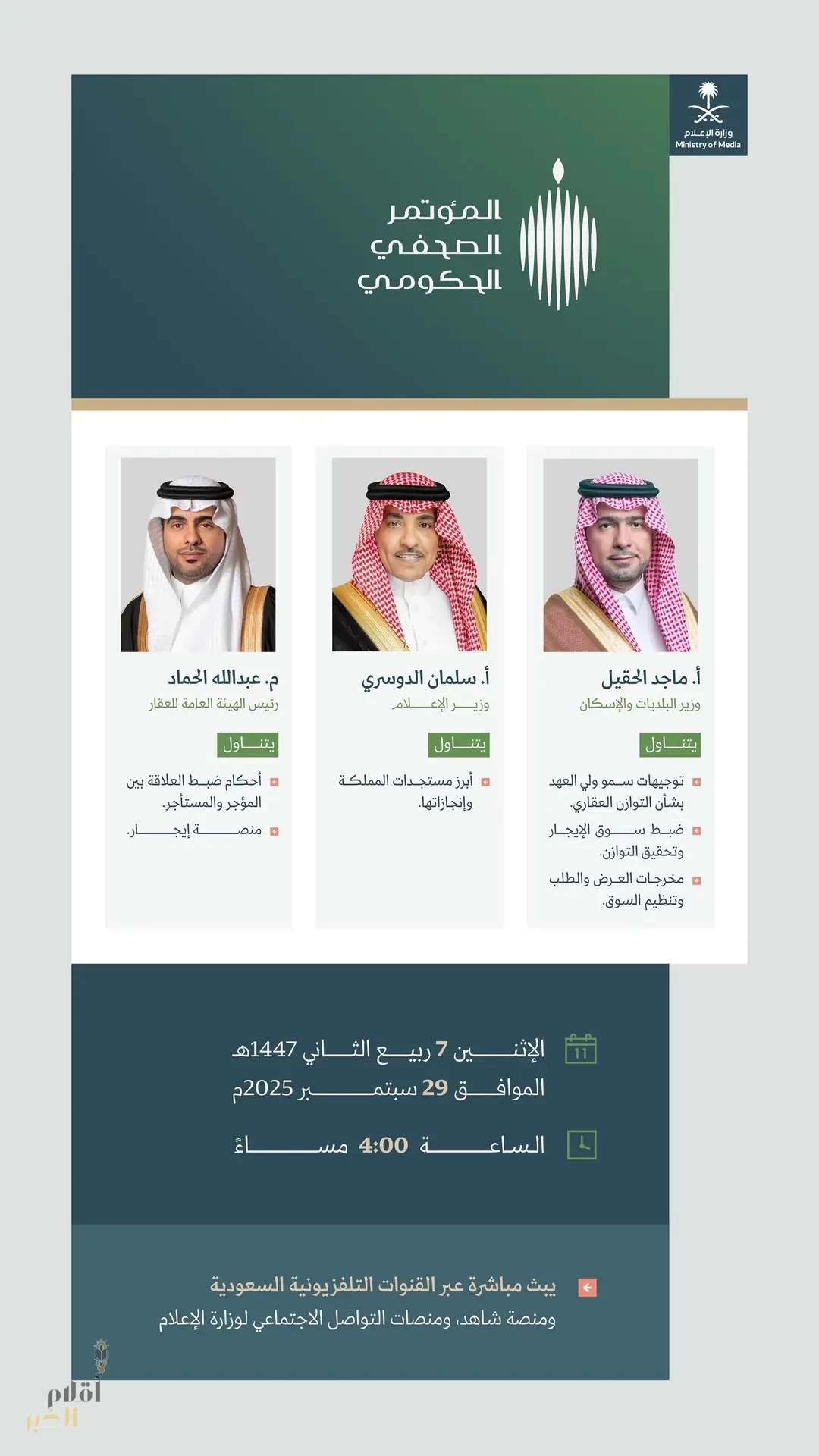



(0) التعليقات
تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات