
✍️ ملهي شراحيلي
يُحكى أن مقاتل بن سليمان، دخل يوماً على الخليفة العبّاسي، أبو جعفر المنصور، فقال له المنصور : عِظني يا مقاتل.
فقال : أعظُك بما رأيتُ أم بما سمعتُ؟
قال : بل بما رأيت.
قال يا أمير المؤمنين: إن الخليفة الأموي، عمر بن عبدالعزيز، أنجبَ أحدَ عشرَ ولداً، وترك ثمانية عشر ديناراً، كُفّنَ بخمسة دنانير، واشتُريَ له قبراً بأربعة دنانير ووزِّع الباقي على أبنائه.!!.
والخليفة الأموي، هشام بن عبد الملك، أنجب أحد عشر ولداً، وكان نصيب كلّ ولدٍ من التركة ألف ألف دينار!!!.
ووالله... يا أمير المؤمنين : لقد رأيتُ في يومٍ واحد، أحد أبناء عمر بن عبد العزيز، يتصدق بمائة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق!.
ومما يؤثر عن عمر بن عبدالعزيز، أنه سُئل وهو على فراش الموت: ما تركت لأبنائك يا عمر؟!؟.
فقال: "تركت فيهم تقوى الله. فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى."
وإنني إذ أذكر هذه القصة البليغة، ومافيها من عظة، في مناسبة اليوم العالمي للأسرة، لألفت انتباهك أخي القارئ الكريم، وأذكّرك ونفسي بقيمة من أهم القيم الأُسرية، وقاعدة من أروع القواعد العائلية، ألا وهي، أن ما يتركه المرء، في أفراد أسرته، أهم بل وأعظم مما يتركه لهم.
سواءً كنا آباء أو أمهات فإن مانتركه من قيم، وما نغرسه من سلوكيات وعادات في نفوس أبنائنا وبناتنا لهو أهم مما نتركه لهم من مدخرات مادية أو مقتنيات، لأن تلك القيم هي التي سوف تقوم عليها أسر في المستقبل.
ولقد صدق عمر بن عبدالعزيز، حين سُئل، ماتركت لأبنائك يا عمر؟
قال: تركت فيهم تقوى الله.
يقول المفكر العالمي، ليو تولستوي :
"إنها الأسرة، إما أن تصنع إنساناً أو كومة عُقد".
والأسرة كما لايخفى على القارئ الكريم، هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبنات العائلة، ومنها تتفرع العوائل، وتتمايز الشعوب والقبائل.
وهنا لابد من الإشارة إلى لطيفة لغوية في منتهى الأهمية، ألا وهي:
الفرق بين الأسرة والعائلة!!!؟.
إن اللغة العربية رغم عمقها اللغوي، وقدرتها على استيعاب المعاني، إلا أنها دقيقة جداً، في مفرداتها، فكل مفردة فيها قائمة بذاتها، ولايمكن أن تشترك كلمتين في نفس الوصف والمعنى لشيء واحد، وإن تهيأ لنا ذلك!.
ومن ذلك مفردة الأسرة، ومفردة العائلة.
فالأسرة في قواميس علم الإجتماع تأتي بمعنى العائلة، والعائلة تعني الأسرة، هذا فيما يخص علم الإجتماع، أما في اللغة فالأسرة تدل على زوج وزوجة وأبناء وبنات، فإذا كانت الأسرة تضم إلى ماسبق جد أو جدة أو عم أو عمة، فهي عائلة.
بعبارة أخرى أن العائلة هي عدد من الأسر.
وعليه فإنه يصح إصطلاحاً أن يقال للعائلة أسرة، ولكن لايصح أن يقال للأسرة عائلة، من الناحية اللغوية.
وعموماً فإن الإحتفاء بالأسرة في ١٥ مايو من كل عام، مناسبة سعيدة، للأسر والعوائل للتذكير بمكانة الأسرة ودورها في المجتمع.
يقول أحد الحُكماء:
"عائلتك هي الشيء الوحيد الذي سيبقى معك للنهاية، فلا تنخدع بازدحام العلاقات".
وهو هنا استخدم مفردة العائلة ولم يستخدم مفردة الأسرة، لأن العائلة، تشمل أسرتك وأسر أخرى، وليس شرطاً أن ترتبط العائلة برب أسرة واحد، أو بناء أو حتى مكان، فالعائلة تضم الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأقارب من أعمام وعمات وأخوال وخالات وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم، وهنا يأتي علم الإجتماع ليقسم العوائل إلى عوائل صغيرة، وعوائل كبيرة، وعندما نقول صغيرة أو كبيرة، فالمعنى ليس العدد، وإنما الأجيال التي في تلك العائلة.
في العصر الماضي كانت العائلة تضم جيل واحد أو جيلين كحد أقصى، أما في العصر الحاضر، فبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهم الله، وما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية، لأبنائها وبناتها من عناية ورعاية، فإننا نجد بعض العوائل تضم أكثر من ثلاثة أجيال.
هذا النمو الأسري، إن صح التعبير، والتوسع العائلي، يجعل الإنسان يفكر في كيف استطاعت الأسر في الزمن الماضي، رغم شح الموارد، وانعدام الرعاية الصحية والاجتماعية، وهشاشة التعليم...
كيف استطاعت رغم تلك التحديات ليس أن تحافظ على قيمها وعاداتها، فحسب، بل واستطاعت أن تنتج للمجتمع أفراد صالحين!!.
فمن نراهم اليوم أطباء ومعلمين ومهندسين ومبدعين في شتى المجالات، جاءوا من أسر وعوائل كانت تئن تحت وطأة الفقر، وتفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وكم من هؤلاء القادة في المجتمع، آباؤهم وأمهاتهم لم يحصلوا على شهادات جامعية، بل أن أغلبهم لايحسنون القراءة ولا يجيدون الكتابة، ولكنهم غرسوا في أبنائهم وبناتهم حب العلم والتعلم.
ولعل من نافلة القول، في اليوم العالمي للأسرة، أن الأسر المضطربة ينشأ عنها أبناء لديهم صورة مشوّهة إما عن أنفسهم أو عن طريقة التواصل في علاقاتهم أو نظرتهم للحياة.
إن هؤلاء الأبناء منهم من يتأمل كيف عاش حياته، ويتفكر في القوانين التي تربى عليها، ويحلل نوع الأسرة التي نشأ بها ثم يعيد تصحيح نفسه من جديد فهو بعد توفيق الله امتلك وعياً استطاع انقاذ نفسه، وماتبقى من عائلته، وبالتالي مجتمعه.
وماذا عنك أخي القارئ الكريم:
هل تفكّرت يوماً بالطريقة التي نشأت بها؟
هل فكّرت في الشيء الذي سوف تقوم بتغييره فيما لو أنشأت أسرة؟.
أنا شخصياً لا أؤيد أبداً لوم الوالدين، فليس كل طرقهم خاطئة، وما فعلوه كان أقصى ما وصل إليه علمهم ذلك الوقت، وأنت المسؤول عن نفسك الآن.
تفكر، تأمل، أعد بناء نفسك، تعلم وأنشئ الأسرة المستقرة والمتوازنة التي طالما حلمت أن تحظى بها.
إن الحقيقة التي لايمكن تجاهلها أن العلم، بعد توفيق الله، قادر على انتشال المجتمع بعوائله وأسره، ولكن العلم يحتاج إلى قيم أسرية وقواعد عائلية، بل إن أهم العلوم وأعظمها لايمكن تعلمها في المدارس ولا حتى الجامعات، لأنها أصلاً ليس معارف ولا مهارات، بل هي أخلاق وطبائع تُكتسب بالممارسة والسلوك بين أفراد الأسرة، ثم العائلة، ثم المجتمع بما فيه المسجد والمدرسة.
فالطفل يحتاج إلى أب صادق، وأم صادقة، لكي يتعلم معنى الصدق.
ولن يتعلم الأطفال بنين كانوا أو بناتاً معنى الصبر، وضبط النفس، والحب والعطف والرحمة، والكرم والنبل، مالم يلمسوا ويعيشوا ويشاهدوا بأم أعينهم هذه السلوكيات في أسرهم.
ولاننا في مجتمع بشري، ولا يوجد مجتمع ملائكي على الأرض، أو كما قال أفلاطون، عن المدينة الفاضلة، فنحن جزء من مجتمعات فيها الخير وفيها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى، وفي ذات الوقت في المجتمع من المساوئ ما لايعد ولا يحصى.
وكما قال أحد الحُكماء:
أخطاؤنا جزء من إنسانيتنا، وإلتزام البعض بمظهر المثالية ليس إلا تمثيل مُتقن، فالكمال ليس من طبيعة البشر.
وأخطر خطر يهدد الأسرة، ليس مافي المجتمع من نقائص ومساوئ، وإنما ما في الأسرة من سلوكيات مثالية مبالغ فيها، وتربية النشيء بطريقة الصح والخطأ، والزام الأطفال بسلوكيات لا تتوافق وعمرهم الفكري ولا حتى عمرهم الجسدي.
إن تدريب الأطفال على تقبيل رؤس كبار السن، وتوبيخهم إن لم يفعلوا لهو جريمة في حق طفولتهم، وتقزيمهم منذ صغرهم، مما يجعلهم عرضة للشعور بالنقص والدونية.
والزام الفتاة التي لم تبلغ الحُلم بالعباية لهو تشويه لبراءتها، وامتهان لكرامتها وطفولتها، ومن أقصر السبل لتعليمهاء الرياء.
ومثل ذلك أساليب التهديد والوعيد التي قد تطور للعنف الأسري ضد الأطفال بسبب سلوكياتهم الطبيعية أصلاً، فإذا كنا نحن الكبار من طبيعتنا الأخطاء، فما بالك بالأطفال!!!.
وما من أب ولا أم إلا ويتمنون أن يحقق أبنائهم وبناتهم أعلى الدرجات في التحصيل العلمي، وأن يكون أبنائهم من الأوائل، ولكن المشكلة إذا جاء ذلك على حساب طفولتهم وحقوقهم الأسرية!!.
بل إن بعض مشاكل صعوبات التعلم أغلبها حرص الأسرة على نبوغ إبنها أو بنتها، وتحميله مالا يطيق، وبشتى الأساليب التربوية الأسرية القاصرة.
إن الإحتفال باليوم العالمي للأسرة فرصة لكل أسرة أن تعيد حساباتها في أساليب التربية الأسرية، وتراجع أفكارها حول القيم الأسرية والعادات العائلية.
إن اليوم العالمي للأسرة، فرصة لنا جميعاً أن نحتفي بالأسرة وبمنجزاتها ونحتفي بمنجزات كل فرد منها، ونثني على الشاطر فيها، ولكن ليس على حساب من أخفق، بل من بديهيات التربية أن نفرق بين الفعل والفاعل، ولا نربط حبنا وتقديرنا لأبنائنا وبناتنا بتفوقهم ولا بإخفاقاتهم.
إن احتياج الأطفال خاصة، والأسرة بصفة عامة، لأجواء الحب والبهجة لاسيما من قبل الآباء والأمهات، لاتقل أهمية عن الاحتياجات المادية للأسرة، والشعور بالأمان الأسري، أهم للأطفال من كل الهدايا والألعاب، وإن أكبر مشكلة تواجه الأسرة، ليس التفكك الأسري، ولا حتى الإنحراف، لأن هذه نواتج طبيعية لتراكمات تربوية خاطئة، ولكن الخطر الأعظم الذي يهدد الأسرة وبالتالي المجتمع، هو العيش في قلق وخوف، ورعب دائم، وتوجّس، فينشأ الأطفال، معاقين فكرياً ومتخلفين إجتماعياً، تنقصهم الثقة في أنفسهم، فلا يثقون في أحد، ولا يثق بهم أحد، وهؤلاء الأطفال يكونون عرضة أكثر من غيرهم للأمراض النفسية والجسدية، ناهيك عن الانحرافات الفكرية والعقائدية التي يتبناها أولئك الأطفال، وينغمسون فيها، سواءً كانت يسارية أو يمينية.
وبما أننا بفضل الله أسر مسلمة، وتربيتنا الأسرية تقوم على مبدأ [ كلكم راعٍ، وكلكم مسؤل عن رعيته].
فمن المسؤلية الأسرية أن نتعلم الأساليب الأسرية الصحيحة التي تضمن للأسرة ازدهارها ونموها، ونحارب بالفعل والقول كل الأساليب التربوية الخاطئة، حتى وإن كانت متجذرة، أو منتشرة.
ولقد صدق المفكر الذي قال:
نحن نتعلم من أطفالنا أكثر مما نعلمهم.!.
إن السلوكيات الخاطئة التي تظهر بين أفراد الأسرة، لها دلالات تربوية، ومعاني اجتماعية، ويجب أن نخضعها للفحص والتأمل، قبل أن نبادر إلى نبذها ومحاولة طمسها بالازدراء والمنع.
فالطفل الذي يكذب مثلاً ليس شرطاً أنه سمع أحد أفراد الأسرة يكذب، أو أن أحداً ما كذب عليه، ولا هو يكذب لمجرد الكذب أصلاً، إنما هو بسلوكه هذا يعبر عن خيال طفولي بريئ، وقبل زجره أو ردعه يجب أن نتعمق في دراسة سلوكه هذا، إلى أبعد مانستطيع أن نصل معه فيه، مستخدمين معه الصدق والواقعية حتى يفرق بين الكذب والخيال.
إن الأسرة التي تحارب السلوكيات الخاطئة، بالمنع والتأنيب، دون البحث عن جذور تلك السلوكيات، هي في الحقيقة أسرة تحتاج إلى إعادة تأهيل.
إن اليوم العالمي للأسرة، يذكرنا أن العالم أصبح أسرة واحدة، لاسيما في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم، والانفتاح التقني المتمثل في الألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل الإجتماعية، ومما لاشك فيه أن محاولة فصل الأسرة عن العالم أصبح صعباً إن لم يكن مستحيلاً، والحل من وجهة نظري الشخصية، ليس في منع وسائل التقنية، ولا حتى في مراقبتها، وإنما في البحث عن أساليب تربوية أسرية تتماشى مع الحاضر، وتستفيد من الماضي، لصناعة مستقبل مشرق للأجيال.
إن إدمان الألعاب الإلكترونية كمثال من أمثلة التحديات التربوية في وقتنا الحاضر، يحتاج منا كآباء وأمهات لانتشال فلذات أكبادنا من تلك الأجهزة، ولعل من أهم أسباب إدمانها ليس سوى تعبير عن حاجة أولئك المدمنين لها إلى الإهتمام بهم والشعور بأهمية وجودهم، واشراكهم في فعاليات الأسرة، هذا إذا كان للأسرة فعليات غير تلك الأجهزة.
أما إذا كانت الأسرة كلها منغمسة في تلك الأجهزة، فكما قال الشاعر:
إذا كان رب البيت للدف ضارباً
فشيمة أهل البيت الرقص.
إن أسلوب الانتقاد وسرد الملاحظات في كل جلسة عائلية، لاسيما مع المراهقين من أفراد الأسرة، لايقل سوءً من أسلوب ترصد الأخطاء، وتوجيه النصائح.
ومما لاشك فيه أن أسلوب التواصل مع المراهقين، لا يصلح أن يكون هو أسلوب التواصل مع الأطفال، والعكس تماماً، فلكل فئة عمرية أسلوب تواصل خاص.
ولعل من نافلة القول أن عقوق الوالدين ماكان له أن يكون من الأبناء، لو لا عقوق الآباء والأمهات لأولئك الأطفال في طفولتهم، ومن أبسط صور عقوق الآباء والأمهات لأبنائهم جهلهم بأسليب التربية الصحيحة.
وفي اليوم العالمي للأسرة يجب أن نعترف بأخطئنا التربوية، وأن نبتعد عن المثالية الزائفة في تعاملنا، ولا بأس أن نسمح لأطفالنا بالخطأ، ولا نرفع سقف توقعاتنا فيخر السقف علينا.
إن اليوم العالمي للأسرة، فرصة لكل أم وأب أن يراجعوا منتجاتهم الأسرية، ويتفقدوا مخرجاتهم العائلية، بل إن هذه المناسبة فرصة سانحة لنا جميعاً آباء وأمهات في مراجعة أفكارنا فيما يخص أسرنا، وفرصة لنتعلم مهارات تربوية جديدة، فاليوم العالمي للأسرة، يعطينا الأمل أن باستطاعتنا أن نعيد للأسرة أهميتها، ونتدارك ما فاتنا، من تقصير وتفريط في حق أسرنا وعوائلنا، وأن نعيد توجيه استثمارتنا في أصول الأسرة، مادياً ومعنوياً.
وكما قال الطغرائي، (بتصرف)
سأحجُبُ عنّي أُسرتي عند كبوتي
وأبرز فيهم إِنْ أصبتُ ذكاءَ
ولي أُسوةٌ بالبدر يُمحقُ نورَه
فيخفَى إلى أن يستجد ضياءَ.
وقال آخر:
حبي لأهلي وأولادي وعائلتي
ومن يلوذ بأهلي حب ذي شيم
فمن أحبّهُمُ أحببتُه علناً
وباطناً وأنا ضد لضدهم
الأقربون بهم أوصى الإله وذا
سر لعارف معنى وصلة الرحِم.
MelhiSharahili@gmail.com




















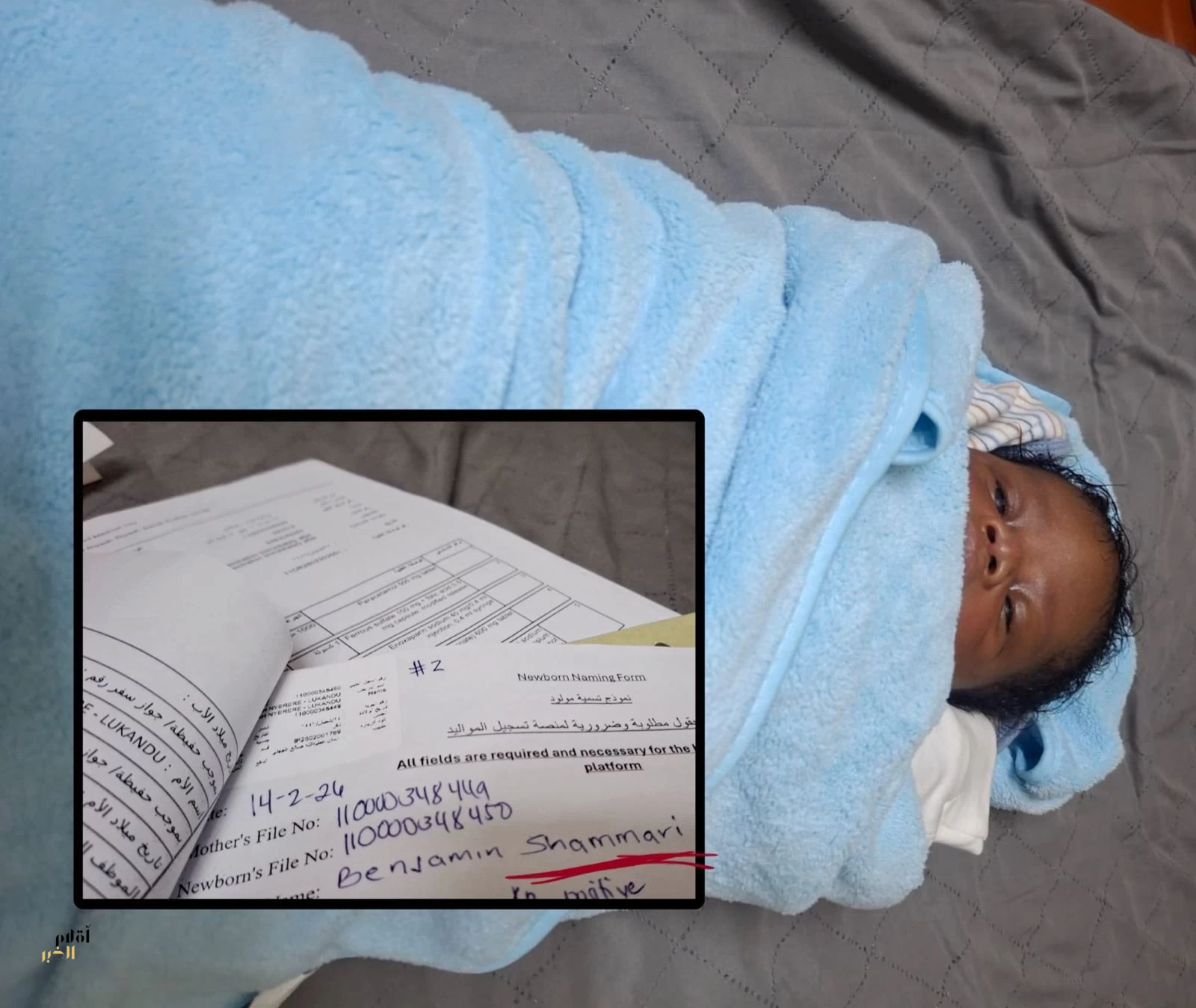


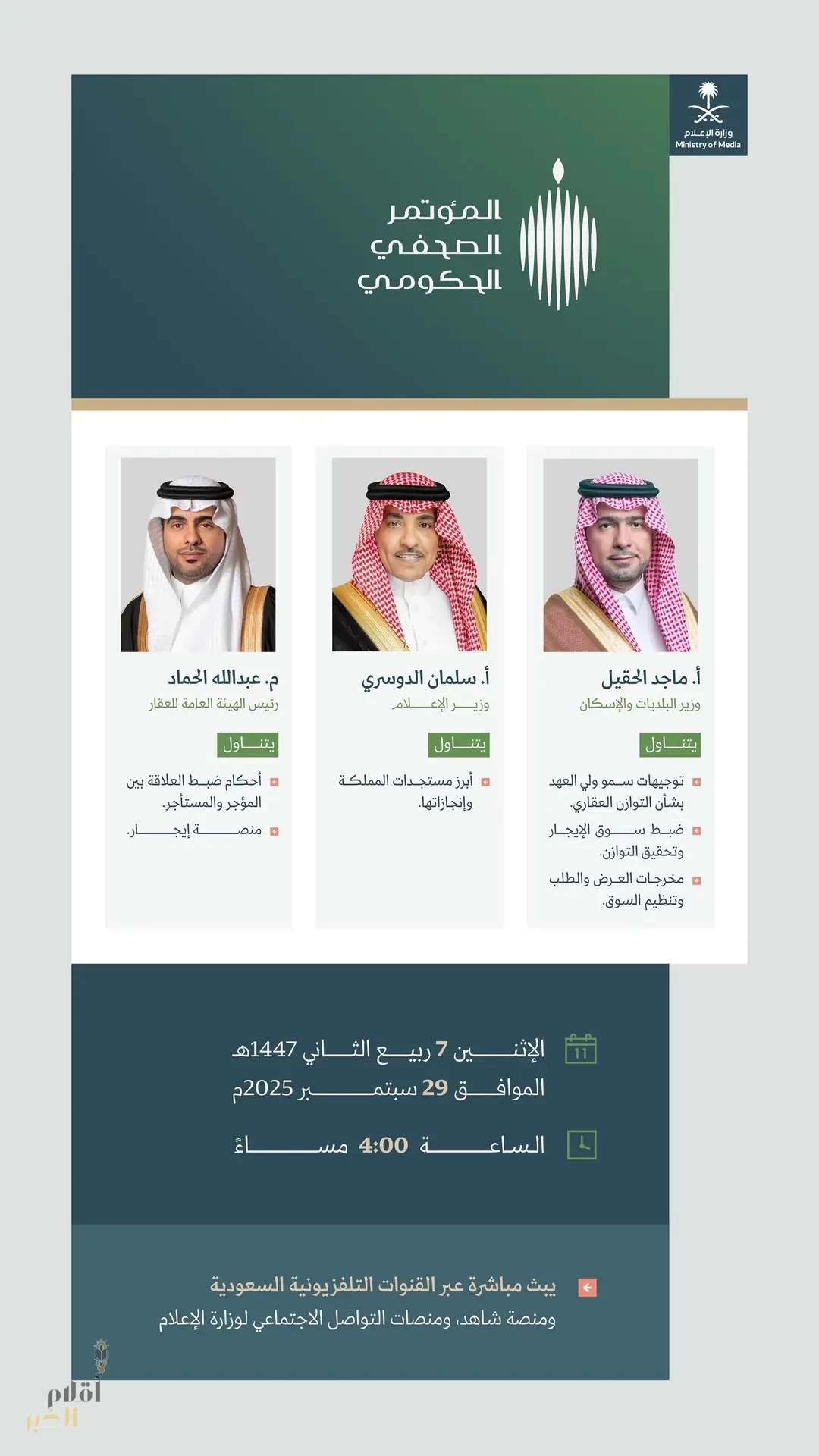




(0) التعليقات
تسجيل الدخول
إضافة رد على التعليق
الردود
لا توجد تعليقات